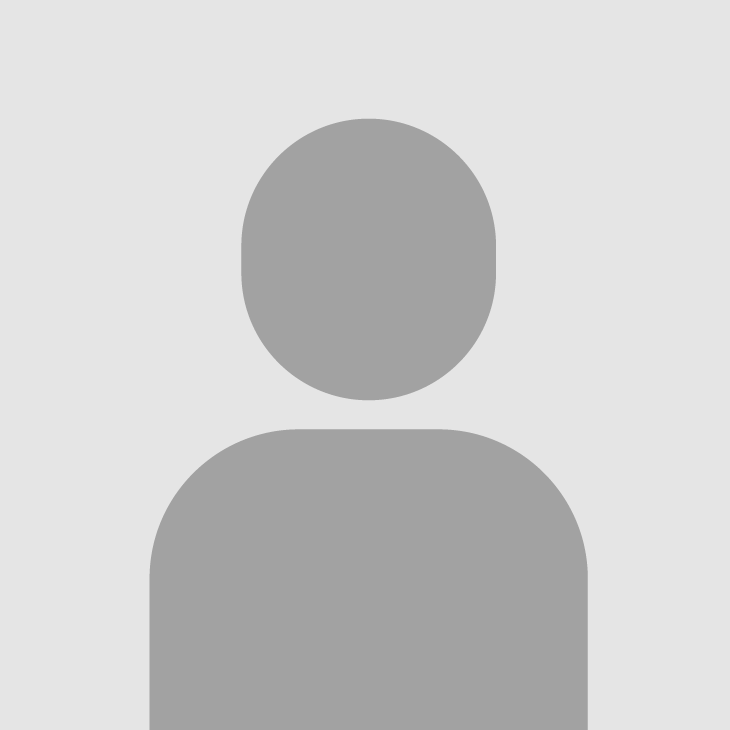في عالم تتنازعه التقويمات والمناسبات، تبقى الأشهر الهجرية عنصرًا مركزيًا في الحياة الإسلامية. من الصوم إلى الحج، ومن الذكرى إلى العبادة، ترتبط هذه الأشهر ارتباطًا وثيقًا بهوية المسلمين ومناسباتهم.
التقويم الهجري وأهميته
تعتمد البلاد العربية التقويم الميلادي والهجري كمصدر للتأريخ، ويتباين استخدام أحد هذين التقويمين بين الدول؛ ففي منطقة الخليج والمملكة العربية السعودية خاصة يقومون باستعمال التقويم الهجري، ويتم التأريخ بأشهره الهجرية وتوثيق الأحداث والشواهد بهه، وهو التأريخ المعمول به والمعتمد في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية هناك، في حين أن بلاد الشام والمغرب العربي تعتمد التقويم الميلادي، وتوثق الأحداث فيها بالأشهر الميلادية، مع ارتباط بالتقويم الهجري لاتصال هذا التقويم بكثير من المناسبات الدينية وتحديدها، كشهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، ومناسك الحج وغيرها، وسنتعرف فيما ما يأتي لأشهر الهجرية وأقسامها وترتيبها، وسبب تسميتها.
التقويم الهجري: النشأة والاعتماد
التقويم الهجري هو تقويم قمري؛ أي يعتمد على حركة القمر في تحديد الأشهر والمواقيت، وقد عرفه العرب واستخدموه قبل الإسلام بقرون، لكن أسماء أشهره لم تكن محددةً، بل كانت تختلف وتتعدد تبعاً لكل قبيلة وما تطلقه من أسماء. عقد في مكة اجتماع لسادات قبائل العرب؛ للاتفاق على توحيد الشهور وأسمائها، وكان ذلك في حياة كلاب بن مرة الجد الخامس للنبي -عليه الصلاة والسلام-، وبعد دخول الإسلام أبقي على التقويم الهجري واعتمد، إلا أن بداية التأريخ فيه كانت في خلافة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ثاني الخلفاء الراشدين، بعد عامين ونصف العام من توليه الخلافة اعتمد الهجرة النبوية لتكون محددةً التأريخ، لذلك سمي التقويم بالهجري وعرفت السنة وأشهرها بالهجرية.
بدأ العمل بالتأريخ الهجري في شهر ربيع الأول للعام السادس عشر للهجرة، ليكون بعدها الأول من محرم للعام السابع عشر للهجرة بداية لأول سنة هجرية بعد اعتماد التقويم الهجري، ويرجع اعتماد الهجرة النبوية في التأريخ لأهمية هذا الحدث للدولة الإسلامية منذ عهد الصحابة -رضي الله عنهم- وحتى هذه الأيام.
تقسيم الأشهر الهجرية: الحرم والحِلّ
تتكون السنة الهجرية عند العرب من اثني عشر شهراً، وقد ذكر القرآن الكريم هذا الأمر في قول الله تعالى: (إن عدة الشهور عند الله اثْنا عشر شهْرًا في كتاب الله يوْم خلق السماوات والْأرْض منْها أرْبعة حرم ۚ ذٰلك الدين الْقيم ۚ فلا تظْلموا فيهن أنفسكمْ ۚ وقاتلوا الْمشْركين كافةً كما يقاتلونكمْ كافةً ۚ واعْلموا أن الله مع الْمتقين)، وقد اعتمد العرب في تحديد وتعيين أوائل الشهور على إهلال القمر؛ فإذا اختفى القمر ولم يظهر فهذه علامة آخر الشهر ونهايته، وبظهور الهلال يعرفون بداية الشهر، وعدوا أيام الشهر الهجري بتسعة وعشرين يوماً أو ثلاثين يوماً، وتتقدم السنة الهجرية كل عام أحد عشر يوماً عن السنة الميلادية؛ بسبب اعتمادها على حركة القمر.
وقد قسم العرب الأشهر الهجرية إلى قسمين وبقي هذا التقسيم في الإسلام كذلك، وهذان القسمان هما:
الأشهر الحرم: وعددها أربعة أشهر، ثلاثة منها متتالية؛ هي ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، والشهر المنفرد رجب، وقد سميت بالأشهر الحرم لأن العرب في الجاهلية كانوا يعظمون هذه الأشهر، ويحرمون القتال فيها، ويمتنعون عن سفك الدماء، وهو ما بقي عليه الحال بعد دخول الإسلام، حيث بقي القتال في هذه الأشهر محرماً، فلا يحل القتال والجهاد إلا بعد انقضاء هذه الأشهر، كما في قول الله تعالى: (فإذا انسلخ الْأشْهر الْحرم فاقْتلوا الْمشْركين حيْث وجدتموهمْ وخذوهمْ واحْصروهمْ واقْعدوا لهمْ كل مرْصد ۚ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهمْ ۚ إن الله غفور رحيم).
الأشهر الحل: وعددها ثمانية، وهي الأشهر الباقية من الإثني عشر شهراً بعد الأشهر الأربعة الحرم، وهي صفر، وربيع الأول، وربيع الآخر، وجمادى الأولى، وجمادى الآخرة، وشعبان، ورمضان، وشوال، وهي أشهر حل لأن القتال فيها كان حلالاً عند العرب في الجاهلية والإسلام.
ترتيب الأشهر الهجرية وأسباب التسمية
أما بالنسبة لترتيب الأشهر الهجرية، فهو على النحو الآتي:
محرم: وهو أول أشهر السنة الهجرية، ومن الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال، ويطلق عليه أيضاً الشهر الحرام.
صفر: وهو الشهر الثاني في السنة الهجرية، وسمي بذلك لأن العرب كانت تترك بيوتها صفراً؛ أي خالية منهم، لخروجهم للحرب، وقيل لأنهم كانوا يتركون من يقابلونهم من الأعداء صفر المتاع في الغزو.
ربيع الأول: سمي بذلك لأن تسميته جاءت في الربيع فلزمته هذه التسمية.
ربيع الآخر: سمي بذلك لأنه يعقب ربيع الأول.
جمادى الأولى: سمي بذلك لوقوع تسميته في الشتاء، وجمادى مؤنث، يراد بها جمود الماء.
جمادى الآخرة: سمي بذلك لأنه يعقب جمادى الأولى
رجب: وهو أحد الأشهر الأربعة الحرم، وسمي بذلك لأن العرب كانت ترجب رماحها؛ أي تنزع النصل من رماحها وتتوقف عن القتال.
شعبان: واختلف في سبب تسميته؛ فقيل شعبان لأن العرب كانت تتشعب في المناطق بحثاً عن الماء، وقيل لأنهم كانوا يتشعبون للقتال بعد امتناعهم عنه في شهر رجب.
رمضان: وهو شهر الصيام في الإسلام، وسمته العرب بذلك؛ لتزامن تسميته مع رموض الحر، أي شدته وشدة وقوع الشمس فيه.
شوال: وهو شهر عيد الفطر عند المسلمين، وسمته العرب بذلك من تشول الإبل، فيقال: تشولت الإبل أي جف لبنها وضعفت.
ذو القعدة: وهو أول الأشهر الحرم، وسمي بذلك لأن العرب تقعد فيه عن القتال.
ذو الحجة: وهو شهر أداء مناسك الحج وفيه عيد الأضحى عند المسلمين، وسمته العرب بذلك لأنهم قبل الإسلام كانوا يحجون فيه كذلك.
الأشهر الهجرية في حياة المسلم اليومية
ترتبط الأشهر الهجرية ارتباطًا وثيقًا بالعبادات والمناسبات الدينية. فمن خلالها نُحدد:
موعد شهر رمضان، الصيام، وليلة القدر.
توقيت الحج ويوم عرفة وعيد الأضحى.
يوم عاشوراء في محرم.
الإسراء والمعراج في رجب.
المولد النبوي في ربيع الأول.
كما أن الكثير من الأذكار والسنن مرتبطة بأيام وليالٍ هجريّة محددة، مما يجعل معرفة التقويم الهجري أمرًا أساسياً في حياة المسلم.
الجديد في التعامل مع الأشهر الهجرية اليوم
رغم أن التقويم الهجري هو جزء أصيل من الثقافة الإسلامية، إلا أن التعامل المعاصر معه أصبح مقتصرًا على المناسبات الدينية فقط، مثل رمضان والحج، بينما يغيب عن الاستخدام المدني اليومي في معظم الدول العربية.
لكن هناك جهود لإعادة إحياء العمل به، عبر:
التطبيقات الذكية التي تدمج الهجري والميلادي.
المؤسسات التي تعتمد التقويم الهجري في توثيق الوثائق الرسمية.
تنامي الوعي الديني بين الشباب بدلالة أسماء الأشهر ومعانيها.
الفرق بين التقويم الهجري والميلادي
الهجري قمري، يعتمد على حركة القمر.
الميلادي شمسي، يعتمد على دورة الشمس.
السنة الهجرية أقصر بـ 11 يومًا تقريبًا من السنة الميلادية.
الميلادي يُستخدم عالميًا، بينما الهجري يُستخدم دينيًا وإسلاميًا.
هذا الفارق يؤدي إلى تنقّل المواسم الدينية في جميع فصول السنة الميلادية خلال دورة زمنية.
استخدام التقويم الهجري في العصر الرقمي
في ظل التكنولوجيا الحديثة، أصبح من السهل على المستخدمين تتبع التواريخ الهجرية عبر:
التطبيقات الإسلامية على الهواتف.
تقويمات إلكترونية مدمجة في نظم التشغيل.
مواقع الإنترنت التي تقدم تحويلًا دقيقًا بين الهجري والميلادي.
هذا الاندماج ساهم في تعزيز الحضور الرقمي للتقويم الهجري حتى بين الأجيال الشابة.
المراجع
جواد علي (2001)، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (الطبعة الرابعة)، بيروت: دار الساقي، صفحة 78-80، جزء 16. بتصرف.